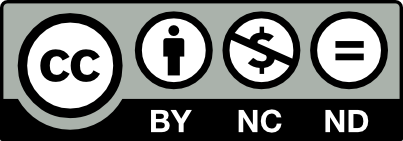العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده
الحسن
بن رشيق المسيلي القيرواني
390 / 1000
المسيلة
-
456 / 1070
مازرة (صقلّيّة)
شاعرٌ وناقدٌ ومُؤرّخٌ للشّعر، وُلدَ
بالمسيلة
التي كانت جزْءا من إِفريقيّة في
العهد الصّنهاجيّ
، وارتَحل إلى
القيروان
سنة 406هـ / 1015م وهو في سنّ الخامسَةَ عَشرَةَ، واتّصل ببلاط
المُعِزّ بن باديس
حيث التقى
بأبي إسحاق إبراهيم الحصري
و
ابن شرف
. رَثا
القيروان
عند
زحف الأعراب
عليها سنة 449 هـ/1057م، وخرج منها إلى
المَهدِيّة
، ثمّ هاجر إلى
صِقلِّيّة
وتُوفِّي
بمازرة
.
من مؤلّفاته
العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده
أنموذج الزّمان في شعراء القيروان
ديوان ابن رشيق
قراضة الذّهب في نقد أشعار العرب
التّعليق من كتاب العمدة في محاسن الشّعر
المزيد من المعطيات على الموسوعة التونسيّة
390 / 1000 المسيلة - 456 / 1070 مازرة (صقلّيّة)
شاعرٌ وناقدٌ ومُؤرّخٌ للشّعر، وُلدَ بالمسيلة التي كانت جزْءا من إِفريقيّة في العهد الصّنهاجيّ ، وارتَحل إلى القيروان سنة 406هـ / 1015م وهو في سنّ الخامسَةَ عَشرَةَ، واتّصل ببلاط المُعِزّ بن باديس حيث التقى بأبي إسحاق إبراهيم الحصري و ابن شرف . رَثا القيروان عند زحف الأعراب عليها سنة 449 هـ/1057م، وخرج منها إلى المَهدِيّة ، ثمّ هاجر إلى صِقلِّيّة وتُوفِّي بمازرة .
من مؤلّفاته
العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده أنموذج الزّمان في شعراء القيروان ديوان ابن رشيق قراضة الذّهب في نقد أشعار العرب التّعليق من كتاب العمدة في محاسن الشّعر
المزيد من المعطيات على الموسوعة التونسيّة
تقديم النّص
يمثّل كتاب العُمدَة « موسوعة » في النّقد العربيّ القديم، وفي فنون البلاغة، وفي علم الأَنساب وأصوله، ومنازل القمر، والأماكن والبلدان، وأيّامِ العَرب وأشعار الخُلفاء والقضاة والفقهاء والكُتّاب، والتكسّب بالشعر والأنفة منه، والمطبوع والمصنوع، وأوزان الشّعر وأعاريضه وأغراضه من غَزل ونَسيب ومَديح وافتخار ورثاء وهِجاء، والصّفات التي يحسُن أن يتحلّى بها الشّاعر، وأوقات صَنعة الشّعر؛ وأبواب البلاغة من استعارة وتمثيل ومَثل سائر وتشبيه وإشارة وكِناية ورَمز وتجنيس، والتّقسيم في المنظوم والمنثور، والاستطراد والالتفات، والحشْو وفُضول الكلامِ، والتَّكرار والوصف، والاستشهاد بالشِّعر، وما انفرد به الشُّعراء، والمآخِذ عليهم، والسّرِقات وما شاكلها.
كما يمثّل الكتاب نقلة نوعيّة من النّاحية النّظريّة والمنهجيّة. ولعلّ هذا ما جعل ابن خلدون يقول عنه : «وهو الكتاب الذي انفرد بهذه الصناعة وإعطاء حقها، ولم يَكتب فيها أحدٌ قبله ولا بعده مثله ». وكلّ ناحية في العُمدَة أكانت نقديّةً أم بلاغيّة أم تاريخيّة، يمكن أن تلتقي بناحية أخرى؛ إذ تَرجع كلّها إلى ما نعبِّر عنه بـ « ديوان العَرب »، فمهما تباعدت المسافاتُ بين النّصوص والقصائد، وتنازع النّقدَة والبلاغيّون من الأحكام؛ فالأمرُ يتعلّق في العمدة بِهذا الدِّيوان من حيث هو سجلّ مآثر العرب ومفاخرهم، والنّسَق الذي يستوعب المُختلف داخله ليبقى نسقا. فليس بالمُستغرب أن يكون العمدة « موسوعة »، إذ هو ينضوي إلى ثقافة تتآخذ علومها وتتواصل؛ فيراوحُ كلّ منها داخل حدود العِلمِ الذي يتخصّصُ فيه، ولكنّه يلوي في الآن نفسه على نَواح من التَّرابُط بينه وبين غيره من العلوم.
يعدّ كتاب العمدة تتويجا لحركة أدبيّة ونقديّة اتّضحت معالمها في النّصف الأخير من القرن الرابع وأَفَلَتْ مع خراب القيروان سنة 449 هـ ثمّ انتقل ما بقي منها إلى صقلّية و الأندلس . ولا يُفهم حقّ فهمه دون ربطه بما أحدثه ابن هانئ وعلي الإيادي ، على سبيل المثال، من حركة شعريّة، وما وطّده القزّاز من علوم اللغة، وما قدّمه النهشلي من خطاب نقديّ.
ولئن خصّص ابن رشيق كتاب " أنموذج الزّمان " لشعراء إفريقيّة ، فإنّ إحالاته في كتب العمدة مشرقيّة أساسا، باستثناء الأبيات التي أوردها لنفسه أو لأابن أبي الرّجال، وآرائه بخصوص ابن هانئ المغربيّ ، ونقوله عن عبد الكريم النّهشليّ و الخشنيّ القيروانيّ .
أهدى ابن رشيق كتاب العمدة إلى أبي الحسن عليّ بن أبي الرّجال ، اعترافا له بالجميل، وقد أورد له أبياتا في باب أشعار الكتّاب، وفي مواطن أخرى.
شواهد
وجدتُ الشعر أكبر علوم العرب، وأوفر حظوظ الأدب، وأحرى أن تُقبل شهادته وتُمتثل إرادته (...)ووجدتُ الناس مختلفين فيه متخلّفين عن كثير منه : يُقدّمون ويُؤخّرون ويُقلّون ويُكثرون، قد بوّبوه أبوابا مبهمة، ولقّبوه ألقابا متّهمة، وكلّ واحد منهم قد ضربَ في جهة، وانتحل مذهبا هو فيه إمامُ نفسه، وشاهدُ دعواه، فجمعتُ أحسن ما قاله كلّ واحد منهم في كتابه، ليكون « العُمدة في محاسن الشعر وآدابه »، إن شاء الله تعالى. وعوّلتُ في أكثره على قريحة نفسي، ونتيجة خاطري، خوف التكرار، ورجاء الاختصار؛ إلّا ما تعلّق بالخبر، وضبطته الرّواية، فإنّه لا سبيل إلى تغيير شيء من لفظه ولا معناه.
- "والبيت من الشعر كالبيت من الأبنية: قرارُه الطّبع، وسُمْكُه الرواية، ودعائمه العِلم، وبابُه الدُّربة، وساكِنُه المعنى، ولا خير في بيت غير مسكون. وصارت الأعاريض والقوافي كالموازين والأمثلة للأبنية، أو كالأواخيّ والأوتاد للأخبية، فأمّا ما سوى ذلك من محاسن الشعر فإنّما هو زينة مُستأنفة، ولو لم تكن لاسْتُغنيَ عنها".
وحدثّني بعضُ أصحابنا من أهل المهدية- وقد مررنا بموضع يعرف بالكدية، هو أشرفها أرضا وهواء- قال: جئتُ هذا الموضع مرّة، فإذا عبدُ الكريم على سطح برج هنالك قد كشف الدنيا، فقلت: أبا محمد؟
قال: نعم. قلت: ما تصنع ها هنا؟ قال: ألقح خاطري، وأجلو ناظري. قلتُ : فهل نتج لك من شيء؟ قال: ما تَقَرّ به عيني وعينك إن شاء الله. وأنشدني شعرا يدخل مسام الجلد رقة. قلت: أهذا اختيار منك اخترعته؟ قال: بل برأي الأصمعي.
(ص. 335-336)
مخطوطات
أكثر مخطوطات
A-MMS- 18439 /None
العنوان على المخطوط : التعليق من كتاب العمدة في محاسن الشعر
A-MMS- 22038 /None
العنوان على المخطوط : التعليق من كتاب العمدة في محاسن الشعر
صور ذات صلة
تشير النّسخة إلى أنّ الكتاب قد ألّف طلبا من ابن أبي الرّجال
معطيات بيبليوغرافيّة
حُقّق « العمدة » عدّة مرّات، منها طبعة أولى فِي تونِس سنة 1865. ولكنَّ المُنتشر منها نشرة محمد بدر الدين النعساني الحلبي، القاهرة، مطبعة السعادة، 1907. 1997، ونشرة النبوي عبد الواحد شعلان، القاهرة، مكتبة الخانجي 2000، ونشرة توفيق النيفر ومحمد المختار العبيدي وجمال بن حمادة، بيت الحكمة، تونس 2009، وهي تتميّز بفهارسها.
- الشنتريني، ابن بسّام، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق إحسان عبّاس (بيروت: دار الثقافة، 1997).
- بويحيى،الشاذلي، الحياة الأدبيّة بإفريقيّة في عهد بني زيري، تعريب محمّد العربي عبد الرزّاق(تونس: المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون الفنون،بيت الحكمة، 1999).
- خلدون، بشير، الحركة النقدية على أيّام ابن رشيق المسيلي (الجزائر: منشورات وزارة الثقافة، 2007).
- Al ʿUmdaẗ fī maḥāsin al-šiʿr wa ādābihi wa naqdih [Texte imprimé] / taʾlīf Abī ʿAlī al-Ḥasan Ibn Rašīq al-Qayrawānī al-Azdī ; ḥaqqaqahu wa faṣṣalahu wa ʿallaqa ḥawāšīh Muḥammad Muḥyī al-Dīn ʿAbd al-Ḥamīd ; العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده [Texte imprimé] / تأليف أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي ; حققه وفصله وعلق حواشيه محمّد محيى الدين عبد الحميد, Édition : الطبعة الخامسة Publication : بيروت : دار الجيل, 1981
- ابن رشيق, الحسن ابن علي القيرواني Ibn Rašīq, al-Ḥasan ibn ʿAlī al-Qayrawānī العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده / تأليف أبي علي الحسن بن رشيق ; حققه و فصله و علق حواشيه محمد محي الدين عبد الحميد. - الطبعة الرابعة Al-ʻumdaẗ fī maḥāsini al-šiʻr wa-ādābihi wa-naqdi-hi / taʾlīf Abī ʻAlī al-Ḥasan ibn Rašīq ; ḥaqqaqa-hu wa-faṣṣala-hu wa-ʿallaqa ḥawāšī-hi Muḥammad Muḥyī al-Dīn ʿAbd al-Ḥamīd. - Al-ṭabʿaẗ al-rābiʿaẗ, بيروت : دار الجيل, [1972]
- Ibn Rašīq, al-Ḥasan ibn ʿAlī al-Qayrawānī, Al-ʿumdat : fī maḥāsin al-šiʿr, wa-ādābihi, wa-naqdihi / taʾlīf Abī ʿAlī al-Ḥasan ibn Rašīq al-Qayrawānī al-ʾAzdī... ; ḥaqqaqahu, wa-faṣṣalahu, wa-ʿallaqa ḥawāšīhi Muḥammad Muḥyī al-Dīn ʿAbd al-Ḥamīd. - al-ṭabaʿat al-ṯāniyat, Miṣr : Maṭbaʿat al-saʿādat, 1955
- Ibn Rašīq, al-Ḥasan ibn ʿAlī al-Qayrawānī, الجزء الأول [- الثاني] من كتاب العمدة في صناعة الشعر ونقده / تأليف أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني المتوفى سنة 463 ; عني بتصحيحه السيد محمد بدر الدين الحلبي. - [Fac-similé numérique] Al-ǧuzʾ al-awwal [- al-ṯānī] min Kitāb al-ʿUmdaẗ fī ṣināʿaẗ al-šiʿr wa-naqdihi / taʾlīf Abī ʿAlī al-Ḥasan ibn Rašīq al-Qayrawānī al-mutawaffá sanaẗ 463 ; ʿuniya bi-taṣḥīḥihi al-Sayyid Muḥammad Badr al-Dīn al-Naʿsānī al-Ḥalabi, Alexandrie : Bibliotheca Alexandrina, 2009,
- Ibn Rašīq, al-Ḥasan ibn ʿAlī al-Qayrawānī, العمدة في صناعة الشعر ونقده / تأليف ابي علي الحسن بن رشيق القيرواني ؛ حققه وعلق عليه ووضع فهارسه النبوي عبد الواحد شعلان. - الطبعة 1. Al-ʿumdaẗ fī ṣināʿaẗ al-šiʿr wa naqdih / taʾlīf Abī ʿAlī al-Ḥasan bin Rašīq al-Qayrawānī ; ḥaqqaqahu wa ʿallaqa ʿalayhi wa ṣanaʿa fahārisahu al-Nabawī ʿAbd al-Wāḥid Šaʿlān,.... - al-Ṭabʻah 1., Al-Qāhiraẗ : Maktabaẗ al-ẖāniǧī bi-al-Qāhiraẗ, 2000
- مخلوف، عبد الرؤوف،ابن رشيق الناقد الشاعر(القاهرة،الدار المصرية للتأليف والترجمة، 1965)
- ابن مماتي, أسعد بن المهذب ابن بسام الشنتريني, علي الذخيرة و طرائف الجزيرة : وهو تلخيص لكتاب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لعلي بن بسام / لابن مماتي, أسعد بن المهذب بن أبي مليح ; تحقيق وتقديم نسيم مجلي القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب, 2001
- عبد الوهاب، حسن حسني. بساط العقيق في حضارة القيروان وشاعرها ابن رشيق (تونس: بيت الحكمة، 2009).
- Ibn Rašīq, al-Ḥasan ibn ʿAlī al-Qayrawānī (1000-1070?), العمدة في محاسن الشعر وآدابه [Texte imprimé], Le Caire, Impr. Ḥijāzī, 1353-1934. 2 t. en 1 vol. gr. in-8°. [Acq. 2053-54] -Xb= ʿAbd al-Ḥamīd, Muḥammad Muḥyī al-Dīn (1900-1972). Éditeur scientifique
- Hawwārī, Ṣalāḥ al-Dīn al, Al-šiʿr wa al-šuʿarā fī kitāb "al-ʿUmdaẗ" fī maḥāsin al-šiʿr wa-ādābihi wa-naqdih li-Ibn Rašīq al-Qayrawānī [Texte imprimé] : dirāsaẗ muǧamiyyaẗ bīblūġrāfiyyaẗ / bi-qalam Ṣalāḥ al-Dīn al-Hawwārī ; ašrafa ʿalayhi wa-rāǧaʿahu Yāsīn al-Ayyūbī ; الشعر والشعراء في كتاب "العمدة" في محاسن الشعر وآدابه ونقده لابن رشيق القيرواني [Texte imprimé] : دراسة معجمية بيبلوغرافية / بقام صلاح الدين الهواري ; اشرف عل, Bayrūt : al-Maktabaẗ al-ʿaṣriyyaẗ, 1997
خالية من الفهارس.